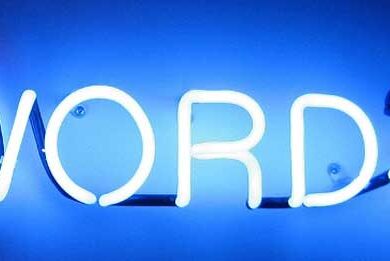كلمات وكلمات سبتمبر وأكتوبر 2019

الهدى 1213- 1214 سبتمبر وأكتوبر 2019
لم تبدأ فكرة الفداء في التاريخ الإنساني مع الديانات الإبراهيمية، لكنها بدأت قبل ذلك بكثير، وذلك منذ أن بدأ الإنسان حياته على الأرض ومن المتعارف عليه أن الإنسان كمخلوق عاقل فكّر في الأخطار التي تحيق به واستطاع بقوة عضلاته أن يهزم الوحوش الكاسرة أو يروضها، مثل الفيل والحصان والجمل والكلب… إلخ؛ ويستخدمها سواء في حروبه ضد الأعداء أو في الزراعة والحراسة مثل البقر والجاموس والحمير… إلخ.
وعندما تعرض لظواهر طبيعية لم يكن يدرك مصادرها أو أسبابها الحقيقية مثل الزلازل والأمطار والرعود والبرق والفياضانات والعواصف الصحراوية… إلخ. في مواجهة هذه الظواهر أرجعها بفكره البدائي إلى قوى أعلى وأقوى منه. بل حولها من ظواهر طبيعية ميتة في حقيقتها أو غير عاقلة لا إرادة لها، إلى قوى روحية عاقلة لها إرادة وهذه القوى العاقلة تهاجمه لكي تبيده.
وقد اعتبرها الإنسان قوى شريرة تحاول إيذاءه وتشريده، وهنا بدأ يفكر كيف يتقى شر هذه القوى الشريرة، من هنا ظهرت فكرة الفداء وذلك بتقديم ذبائح حيوانية وأخرى إنسانية، فإذا قبلت هذه القوى الذبائح سوف تهدأ وتمتنع عن إيذاء الإنسان أو القبيلة وهكذا بدأت الديانات الوثنية بكهنتها الذين غرسوا وعمقوا هذا الفكر، سواء في الممالك الآشورية أو البابلية أو الكلدانية… إلخ.
في هذه الممالك كان يقدم الابن البكر والحيوان البكر للدرجة التي كان فيها تمثال الإله النحاسي المحمي من الداخل حتى الانصهار والذي يمد يديه فيأتي مقدم الذبيحة بابنه الرضيع ويضعه على يدي التمثال الإله ذبيحة حتى يرضى الإله.
وفي اليونان القديمة ظهرت فكرة الآلهة التي تتصارع ولها حياة موازية لحياة البشر ولها كبير (زيوس)، ومنهم الإله الطيب والإله الشرير، ولكن أدرك إبراهيم الإله الواحد وبدأ علاقة صحيحة معه طلب الله منه أن يقدم ذبيحة، ثم ظهر الكبش في الصورة من إعداد الله ليعلّم إبراهيم أنه لا يقبل الذبائح الإنسانية مثل الآلهة الكلدانية والذي كان إبراهيم ينتمي إليها من قبل إيمانه.
لكن المفارقة هنا أن الشعب اليهودي الذي آمن بالله الواحد، كانت له فترات ارتداد في تاريخه، يذكر العهد القديم في سفر القضاة أن يفتاح وهو رئيس (قاضٍ) يهودي قدم ابنته ذبيحة وكانت عذراء، وكذلك الملك منسى قدم أولاده ذبائح لإله الوثن، فقد كان ملوك إسرائيل يتزوجون من بنات ملوك وثنيين ويتأثرون بهم ويبرمون معهم معاهدات إلخ.
إلا أن الخط الرئيسي كان عبادة الله (يهوه) الواحد، وتقديم الذبائح له في الهيكل سواء كانت ذبائح تكفير عن الخطية أو ذبائح شكر، أو ذبائح سلامة تعبر عن شكرهم لمساعدة الله لهم في المرور في ظروف صعبة، وكانت لكل ذبيحة مواصفات خاصة بها، وهذه الذبائح جميعًا في الوثنية أو اليهودية كانت لإرضاء الله، ليحفظهم سالمين أو يغفر لهم خطاياهم، أو ليشكروه بعد مرور الأزمة.
ومن الجدير بالذكر أن في مصر كانت توجد أسطورة عروس النيل التي تُلقى في النيل حتى يفيض دون أن يُدمِر، لكن الدراسات العلمية التاريخية ذكرت أنها لم تكن عروسًا بشرية. وأن التاريخ الفرعوني لم يكن به إطلاقًا ذبائح إنسانية وهو ما يدعونا للفخر بآبائنا.
ثم جاءت المسيحية لتقدم المسيح الذي أُرسل من الله المحب للبشر، ليس إرضاءً للآلهة ولا لمنع الكوارث، ولكن لأن الله يحب الإنسان أرسل يسوع المسيح ليعبر عن فكر الله من نحو الإنسان وما يريده منه من حياة التسامح والغفران ورفض العنف بكل أشكاله، وهكذا رفضت المسيحية كل أنواع الذبائح القديمة في اليهودية وصار المسيح هو الوسيط الوحيد بين الله والناس بمثابة الشفيع.
أما في الإسلام فقد جاءت فكرة الضحية ليس كذبيحة لغفران الخطايا، وليس مقدمة للتعبير عن الشكر أو عبور الأزمة، لكنها نوعية من العلاقة مع الله التي لا تحتاج لتقديم مثل هذه الذبائح، وهي نوع من الإحساس والتعاطف، والوحدة بين المسلمين كشعب واحد يقدمون الأضحية لأجل فقرائهم. لكن السؤال الهام الذي يبحث عن إجابة، هو: لماذا تحول الأمر من إسحق إلى إسماعيل؟ وما هو تفسير الأية وفديناه بذبحٍ عظيم؟
خبرة رعوية
عمل راعينا من مجمل خدمته 30 سنة راعيًا في أربع كنائس وأقل قليلًا من عشر سنوات في العمل العام ثم تفرغ بعد ذلك للعمل العام بالمعنى الأخر أي العمل التطوعي نتيجة انتخابات من القاعدة السنودسية، وفي ذات الوقت دعي الراعي لتدريس المسيحية بجامعة الزقازيق في المعهد المختص بمقارنة الأديان سواء سماوية كانت أم غير سماوية وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ أن يدعى رجل دين مسيحي ليقدم المسيحية لرجال دين من المسلمين. ولأن الحديث هنا عن الخدمة الرعوية، فقد كانت هناك عشر سنوات في الريف، ثم عشرين سنة في العاصمة منها عشر سنوات جاء فيها بعد راع لاهوتي وواعظ متفرد في طريقته وأسلوبه وإدارته، لذلك استطاع أن يستكمل المشوار بعده لأن اتجاه الراعي كان العمق الكتابي والتفسير المبنى على اللغات الأصلية… إلخ ووجد شعبًا مستعدًا أن يدرك التفاسير العملية والحديثة مما جعل الراعي القادم من الريف أن يعمق فكره ويجدده باستمرار، وكان لدى الشعب قبولًا له، بل كانوا يسجلون عظاته سواء على شرائط الكاسيت وكانت هذه أحدث طرق التسجيل حينئذ أو كتابة وكانوا يتحاورون مع الراعي حول أفكاره التقدمية ويتفهمون رسالته. بعد هذه الكنيسة اتجه للعمل العام لمدة عشر سنوات أو أقل قليلًا ثم بدأ في كنيسة أخرى وكان الفارق بين الكنيستين ضخمًا في عدة نواحٍ من أهمها أن الكنيسة الأخيرة أو الثالثة كانت أكثرهم غنى لأن لديها مشروع استثماري، بينما الكنيستان السابقتان لم يكونا كذلك وهذا المشروع يكون سبب بركة في كنائس وسبب لعنة في كنائس أخرى، المهم كانت خلفية الكنيسة الثالثة لاهوتيًا وكتابيًا تختلف تماماً عن الكنيسة الثانية فقد بدأ في السبعينيات أثناء وجود راعينا في الريف والصعيد نوع من الزحف والهجوم على الكنائس المشيخية بالقاهرة من مما يسمى بالهيئات الأجنبية وحاولت هذه الهيئات اختراق الكنائس ومن ضمنها أول كنيسة قام برعايتها راعينا بالقاهرة ومن حسن حظ هذه الكنيسة أنه كان بها الراعي واللاهوتي الذي حدثتكم عنه في بداية (الخبرة الرعوية) والذي تصدى بقوة لهذه الهيئات ودخل في عدة معارك ليحفظ كنيسته، لذلك عندما انتقل راعينا إلى هذه الكنيسة في بداية الثمانينات كانت الكنيسة تقف على قدميها المشيخيتين ولم يصبها من الحرب سوى رذاذ قليل وهكذا استطاع الراعي أن يستكمل المسيرة لمدة عشر سنوات أخرى دون غزو من تلك الهيئات أما ماذا حدث للكنيسة بعد ترك راعينا لها فهذه قصة أخرى سيأتي اليوم الذى نقصها فيه، أما الكنيسة الثالثة التي انتقل إليها راعينا بعد العمل العام لمدة عشر سنوات فكانت قد تم تدميرها من الهيئات الأجنبية وهذه أيضًا قصة ثالثة سوف نحكيها بالتفصيل في المستقبل.
حكاية لاهوتية
كان الحديث يدور في الفصل الدراسي حول الموجة الجديدة من الوعاظ والمفسرين الذين انتقلوا من كنائس محافظة لدرجة الانغلاق، لكنهم كانوا يتوقون للشهرة فجاءت ظروفهم أن سافروا خارج البلاد وتعلموا فن الوعظ والتأثير في البشر وإثارة عواطفهم وقد قبلتهم الكنائس الكبرى بعد عودتهم لشعبيتهم، وفرحوا بهم لأنهم لا يقولون تعليمًا لاهوتيًا عميقًا بقدر ما يقولون عظات عاطفية مؤثرة، ويقلدون كبار الوعاظ العالميين وشغلهم الشاغل هو إطلاق شعارات ضخمة لا تحمل مضمونًا علميًا أو لاهوتياً واضحًا لكنها تثير الناس حول أعداء يصورونهم للشعب أنهم ضد الكتاب المقدس واللاهوت الصحيح وذلك لأنهم يحاولون تفسير الكتاب بالعقل والإدراك وليس بإثارة العواطف ولقد امتلأت الكنائس بالكلام.. كلام… كلام…
وصار الكلام والعواطف والبكاء هم الفيصل، بينما-كما هو معروف لدينا- لم تكن رسالة يسوع كلامًا وبكاًء، ولم تكن رسالة بولس والتلاميذ كذلك، اختلف التلاميذ مع الأستاذ في تقييم الظاهرة معظم التلاميذ ينظرون إلى مثل هؤلاء الوعاظ كأبطال على الرغم من أخطائهم اللاهوتية الواضحة، وتأثيراتهم بمصطلحات مثل «الكتاب المقدس وحده» وهذه الجملة حق يراد به باطل فقد أطلق المصلحون هذه الجملة في عصر الإصلاح ليعلنوا أن الكتاب المقدس هو وحده الذى له السلطان وليس البابا الذى كان سلطانه يتحدى الكتاب المقدس ويتفوق عليه. سأل أحد التلاميذ وما الخطأ أن يرفع الواعظ الكتاب ويتحدث عن سلطانه.
قال الأستاذ: السؤال الأهم «هل يقصد الواعظ بسلطان الكتاب المقدس وحده، أي بدون تفسيره الشخصي ويترك الحرية لآخرين في التفسير أم السلطان للكتاب المقدس وحده بحسب تفسير الواعظ؟! تردد التلاميذ في الإجابة، قال المعلم عندما نقول سلطان الكتاب وحده نعني أن قداسته في ذاته في كلماته وليس في أي تفسير بشرى مهما كان له أن يشارك سلطان الكلمة المكتوبة.
قال تلميذ أخر ما رأيكم موجها كلامه لباقي التلاميذ والأستاذ في تفسير كالفن هل يساوى تفسير كالفن كلمات الكتاب المقدس؟
قال الأستاذ لنقرأ إنجيل يوحنا الإصحاح الأول: وبدأوا القراءة « في البدء كان الكلمة… والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدًا…. به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيئا مما كان… إلخ
قال الراعي أنظروا إلى الكنائس هذه الأيام وأجيبوا على السؤال التالي:
هل قال الوحي الإلهي: الكلمة صار جسدًا أم الجسد صار كلمة بل كلامًا.
قال التلاميذ ماذا تعنى بهذا السؤال؟
أجاب الأستاذ حاولوا أن تجيبوا على هذا السؤال في ضوء الكنيسة الأولى وفهمهم لتجسد الكلمة. فكما اتفقنا منذ البدء أني لا أجيب على كل الأسئلة.
مختارات
«إذا شعرت أنك بحاجة ليد دافئة
أمسك يدك الأخرى، لن يهزم
شخص يؤمن بنفسه»
ريم كافاروين