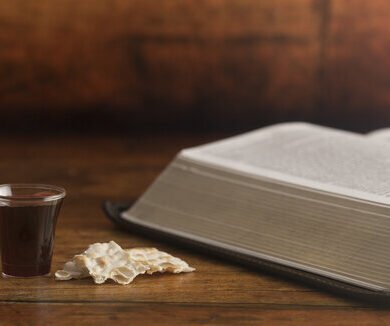المقالة العشرية في الاصلاحات الكنسيّة

الهدى 1260 – 1263 سبتمبر – ديسمبر 2024
فتحت عينيّ -وكثيرون من جيلي- على نبوءة دوّنت ربما قبل أن نولد، تقول إنَّ شمس الكنيسة المشيخيَّة آفِلةٌ بحلول 2025! الصَّادم في هذه النبوءة هو شخص ومكانة قائلها. وبينما تقترب سنة تحقق النبوءة، ترتفع على الطرف الآخر رايات تقول: «الكنيسة بخير.» وما بين هذه وتلك، ما من سبيل للتنصل من مسؤولية البحث، ومحاولة الفعل. في هذه المقالة -وكما يعلن عنوانها- أضع عشرة نقاط ترصد الخلل -بالتأكيد في رأيي- وتفتح سبيل العلاج. وأنا وإن كنت أرجو شيئًا من حديثي هذا، فلست أرجو إلَّا أن تتحول هذه الورقة إلى ورشة عمل تمُدُّ طاولة نقاش، ينتج عنها آليات وقرارات تصنع المستقبل.
أوّلًا، في النَّقْد
ذات يوم أبصرت الفتاة العربيّة النجديّة زرقاء اليمامة، والتي قيل إنها كانت تُبصر الشَعَرةَ البيضاء في اللبنِ، وترى الشخصَ مِن على بعد يوم وليلة. يروى عنها أنها حذّرت قومها من شجر يسير، فلم يصدقوها وسخروا منها. وما كان ذلك الشجر إلا جيوش الأعداء في طريقها إلى قبيلتها. عادت فزعقت تنبه الرجال للخطر المحدق بهم، ولأنها كانت تبصر ما لم يبصروه، اتهموها بالجنون واستمروا على تراخيهم حتى أطبق عليهم الأعداء وفقأوا عينيَّ زرقاء اليمامة!
لم تكن بنود لوثر التي أطلقت شرارة الإصلاح عشيّة ليلة الأربعاء 31 أكتوبر عام 1517 في الأساس سوى نقدٍ لفهم ومسار الكنيسة وسلوك رجالاتها. لذا فالانضواء تحت لواء الإصلاح يُحتِّم عليك أنْ تنحازَ واعيًا لبَركةِ النَّقدِ، وأنْ تُجلَّ عمل النُقَّادِ بينك، وتستجيب لتنبيهاتهم، فهم زرقاء اليمامة وسطك، وإحدى آليات تصحيح المَسَار، وإبقاء الكنيسة دائمًا مُصْلَحَة.
ناديت -وما زلت- بمؤتمر علميّ سنويّ للكنيسة المشيخيّة المصريّة، يطرح دراسات وقراءات تستقصي واقعنا، ويقترح حلولًا مؤسسة على منهاجيّات علميّة أكاديميّة، بعيدًا عن مشاحنات الصِّغار وثغاء القطيع. وتمنيت أن يكون عنوانه الدَّائم: «دائمًا مُصْلَحَة».
ثانيًا، في الضَّمير
«ما لَمْ تُقْنِعْنِي مِن الْكَلِمَةُ الْمُقَدَّسَةُ، أوِ الْمَنْطِقُ الْواضِحُ، فإِنَّنِي لَنْ أَتراجَعَ! فَإِنَّ ضَمِيرِيَ أَسِيرُ كَلِمَةِ اللّٰهِ، وَالسُّلُوكُ فِي مُخَالَفَةٍ للضَّمِيرِ لَيْسَ صَائِبًا أَو آمِنًا. هُنَا أَقِفُ. لَيْسَ بِيَدِي شَيْءٌ آخَرُ! وَلْيُعِنِّي اللّٰهُ.» كانت تلك كلمات لوثر في مجمع ورمز، حين دُعي للتَّخلي عن أفكاره وأطروحاته. عبر تاريخ الكنيسة، تحدَّث كبار المفكرين المسيحيِّين عن الضّمير بشكلٍ منتظم. قال توما الأكوينيّ: «إنَّ الضَّمير هو الصَّوت الدَّاخليّ المُعطَى من اللّٰه، والذي إمَّا أن يتَّهمنا أو يعذرنا فيما يتعلَّق بما نفعله.» وتحدَّث چون كالڤن عن «الحسّ الإلهيّ» الذي يضعه اللّٰه في كلِّ شخص، وجزء من هذا الحسّ الإلهيّ هو الضَّمير. وإذا انتقلنا إلى الكتاب المُقدَّس، نجد أن ضمائرنا هي أحد جوانب إعلان اللّٰه فينا وبنا.
وعليه، لا إصلاح يُرجى في ظل ضمائر موسومة بتعليم كاذب أو أنانيّة أو ربح قبيح. وإصلاح الضَّمير الكنسيّ لن يتأتى إلَّا بإقامة كلمة اللّٰه بوصلة للعبادة والتّعليم بدلًا من عظات ومناهج تعليم -خاصَّة بين الشباب- تقوم بالأساس على أفكار التنمية البشـريَّة وعلم النفس، اللذان يتعارضان في عديد من الحالات مع الفِكر الكتابيّ؛ يكفي أن تنظر إلى قمة هرم (ماسلو) التي تتربع عليها الذات تلك التي يدعونا الكتاب إلى إنكارها! أصلي أن تعود كنائسنا فتعطي الكلمة المقدَّسة مركزيتها في كل تعليم داخلها وتنهل من مائها المُروي، عِوضًا عن آبار أخرى حفرناها لسنين وسنين لم تُرو، بل سمَّمت نقاوة التّعليم، ووسمت الضَّمير!
ثالثًا، في العبادة
«وَأَخَذَ ابْنَا هَارُونَ: نَادَابُ وَأَبِيهُو، كُلٌّ مِنْهُمَا مِجْمَرَتَهُ وَجَعَلاَ فِيهِمَا نَارًا وَوَضَعَا عَلَيْهَا بَخُورًا، وَقَرَّبَا أَمَامَ الرَّبِّ نَارًا غَرِيبَةً لَمْ يَأْمُرْهُمَا بِهَا. فَخَرَجَتْ نَارٌ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ وَأَكَلَتْهُمَا، فَمَاتَا أَمَامَ الرَّبِّ.» (اللَّاويين 10: ١، ٢) حاول ابنا هارون أن يتواصلا مع الله بطريقتهما الخاصّة، بعيدًا عن التّرتيب المُحدَّد الذي أعلنه الله لموسى. لا ندري طبيعة دوافعهما. ربما وجدا تكرار الذبائح على مدى الأيام السّبعة (لاويين 8: 35) مُملًّا، فأرادا شيئًا جديدًا مثيرًا لكسْر ما عدّوه رتابة. لكن مهما كانت دوافعهما، واضح أنَّها لم تكن مقدَّسة ولم يرض الرَّبُّ عنها.
عَدَّ المُصلِحون العِبادة هي لقاء اللّٰه، لذلك جاء اهتمامهم بأركان العِبادة: الصلاة، العِظة، والترنيم. فحرصوا على تضمين العِبادة صلوات تشاركيّة مكتوبة، تضمن الانضباط والتعليم في آن واحد (ليتورچيا)، وصلوات فردية تؤكد وتُرسِّخ حرية العابد في الاتصال بالمعبود، اتصالًا شخصيًّا.
وعليه:
- تقدَّم العبادة للّٰه وَفق ما نظَّمه -جل اسمه- لا وَفق استحسان البشر؛
- حريَّة العبادة التي قدَّمتها كلمة اللّٰه حريَّةً في اتصال العابد بالمعبود دون وساطة (أو بالأحرى في وساطة المسيح وحده)، وليست حريَّة ابتداع العبادة؛
- كلَّ ابتداع على خلاف وصيَّة اللّٰه هو «نارٌ غريبةٌ» ولو كان مقدِّمها من بيت هارون أو موسى؛
- نظَّم الوحي العبادة في سفر اللَّاويين ليحفظها الشَّعب، ولو أنّ بعض المُمارسات الفرديّة في حالات استثنائيّة كانت من جوهر العبادة لما أغفلها الوحي (هذا بالتأكيد لمن يسلِّمون بعصمة الوحي).
سارت الكنيسة في سفر الأعمال على المنوال نفسه. وجاءت أركان العبادة محدَّدة في: تعليم الرُّسل، الشَّركة، كسر الخبز، الصَّلوات، المعموديَّة. ويستعرض سفر الأعمال ورسائل بولس الرَّسول كيف التزمت الكنيسة بممارسة نمط العبادة، وكيف واجه الرُّسل كل انحراف عنه. وعلى النهج نفسه، سار المصلحون ورفضوا كل إضافات بشريَّة على العبادة. يقول كالڤن -مثلًا- في تفسيره للوصايا الأربع الأولى: «يجب أن نعبد اللّٰه بالطّريقة التي يراها هو، وليس للإنسان أن يُضيفَ أفكارًا، أو عناصرَ غريبة إلى العبادة الحقّة للّٰهِ الحي…إنَّ الذهن الإنساني هو أرض خصبة لزرع بذور عبادة مُزيفة، تنمو في الإنسان، فالقلوب البشريّة هي مصانع الأوثان.» وعليه، أزال كالڤن من كاتدرائية القديس بطرس كل ما يمكن أن يخطف انتباه المُتعبد، ويفصله عن الارتباط باللّٰه بارتباطات أُخر، كما اهتم بربط عظاته بالكلمة المقدَّسة وتفسيرها فقط، إيمانًا بمحورية وسلطان الكلمة.
والآن، القوسان مفتوحان لنرصد بينهما كل إضافات حشرناها على العبادة فخطفت أنظار المتعبدين، وكل ارتباطات وصلناها بالعبادة فجرّتها بعيدًا عن جادة الكلمة المقدَّسة وسلطانها! لكم كنت سعيدًا بافتتاح مركز مرثا روي للعبادة في كلية اللاهوت الإنجيليَّة في القاهرة، ومنَّيت نفسي بكثير من الإصلاح، وحلمت بتأثير عظيم على قدر عظمة الراحلة مرثا روي، ثم هبط عليَّ كالصاعقة خبر تخلي الكليّة والكنيسة عن المركز وإغلاقه، حينها أدركت أن العبادة لم تعد أولويَّة!
كان الانضباط قيمة أساسيَّة في حركة الإصلاح، وسمتًا بارزًا فيها، ويبقى هو الضامن والواعز لانضباط الإدارة الكنسيّة، والحياة الشخصيّة، ومُحددًا لسعي الكنيسة أن تبقى دائمًا مُصْلَحَة.
رابعًا، في الوَعظ
فيما يخص العِظات، انطلاقًا من إيمانهم بقوَّة وسُلطان كلمة اللّٰه، أصرَّ المُصلِحون على محوريَّة النَّصّ الكتابيّ، والميل إلى التفسير الحرفيّ للنَّصّ، الذي يُراعي السِّياق والقرينة، مُفسحين المجال للنَّصِّ ليقول ما يريد دون تأويل أو التفاف. شدَّد المُصلحون على أهميَّة أن يعتلي الواعظ المِنبَر وقد استعد بدعوة إلهيَّة، وجهد دراسيّ، وصلوات طويلة، وفي معرض تفسيره لقول الكتاب: «لا تُجرب الرب إلهك.» أوضح كالڤن أنَّ التقدم للوعظ دون استعدادٍ بمثابة أنك تُجرب الرَّبَّ إلهك.
على الكنيسة المُصْلحَة أن تعود فتنظر في حالِ الوعظ فيها، فقد أصبح قوام غالبية العظات، إما حكايات يعلم اللّٰه صدقها، أو قوالب مصفوفة من مناهج القولبة البشريّة؛ فإصلاح الوَعظ إصلاحٌ للعِبادة والتّعليم، وإبقاء للكنيسة المُصْلَحة دائمًا مُصْلَحَة.
خامسًا، في التَّرنيم
لكي تكتمل معزوفة العِبادة، وتخرج في أبهى النغمات، كان لا بُد من ضبط إحدى ركيزاتها، وهي التَّرنيم، فعمل المُصلحون على تنقية الموسيقى، واستبدلوا كلمات الترانيم بكلمات المزامير، التي كانت تحمل قيمة خاصة لديهم، ولدى كالڤن بالأخص، الذي عدَّ المزامير كتاب ترنيم الكنيسة. وفي معرض حديثه عن التَّرنيم في العِبادة، يرى كالڨن في كتابه أسس الدين المسيحي، أن الترتيل يجب أن يكون وقورًا، فذلك يضفي كرامةً وجمالًا على العِبادة، ويوقد مشاعرنا لغيرة حقيقيّة، واشتياق قلبي إلى الصَّلاة.
ماذا تُرنِّم الكنيسة اليوم؟ بمَ استبدلنا نظم المزامير؟ ما حال الألحان والكلمات؟ هل يدرك قادة التَّسبيح دورهم في قيادة فترات العبادة الجماعيَّة؟ عشرات الأسئلة المفتوحة، فهل تمد الكنيسة طاولة نقاش لملف التَّرنيم، أم تترك الساحة لكل شيخ وطريقته؟! أظننا ابتعدنا كثيرًا اليوم عمَّ أسسه المُصلَحون في الترنيم! إصلاح الترنيم من إصلاح العبادة، وإصلاحهما، يُبقي الكنيسة دائمًا مُصْلَحَة.
سادسًا، في التَّعليم
قال كالڤن: «لا يجب إعداد خدمات العبادة وترتيبها بناء على اعتبارات براجماتيّة، إنما بناء على مبادئ لاهوتيّة، نابعة من كلمة اللّٰهِ.» كان لمركزيّة المِنبر في الكنائس المُصلَحة شأنٌ كبيرٌ، إذ ارتكز تعليم الكنائس المُصلحة وتمحوّر حول كلمة اللّٰه. قدم كالڨن 159 عظة من سفر أيوب بين عامي 1554-1555 و200 خدمة من سفر التثنية بين عامي 1555-1556 و 48 عظة من رسالة أفسس في العامين 1558 و 1559 و 65 عظة من الأناجيل الإزائيَّة عام 1560 و 194 عظة من صموئيل الأول والثاني خلال الفترة من 1561 إلى 1563. نبع هذا من إدراك المُصلحين لمركزيّة وأهميّة وعصمة كلمة اللّٰه، ونفعها للمؤمنين.
هذا ما أذكره فأسكب نفسي عليَّ! إذ ضجت منابرنا، وعظاتنا، وحتى دروس تعليم الكتاب المقدس اليوم بالدعاوى البراجماتيّة، والإيماءات والتوجيهات السياسية -المُستترة والمُعلنة-، وانتهجت قواعد التسويق، ومناهج القولبة البشريّة؛ وانحرفت ترتشف من ينابيع غير ينبوع الكلمة.
هل تعود الكنيسة اليوم للتدقيق في أمر التعليم ومناهجه؟ هل تضطلع بمهمتها في ضمان انضباط المعلمين وتَلَقيهم القدر الذي يؤهلهم للتعليم؟ هل تتسق أمانة الخدمة وفوضى المؤسسات التعليميّة الوهمية التي امتهنت الحياة الأكاديميّة؟ والسؤال المعتاد، هل تمد الكنيسة طاولة للنقاش والتخطيط لهذا الأمر؟ في يقيني، أنه لا إصلاح مرجو لتعليم الكنيسة بعيدًا عن الكلمة المقدسة، التي هي غذاؤها وترياقها وضمان بقائها دائمًا مُصْلَحَة.
سابعًا، في النَّبويَّة
عام 1870م، طالبت الكنيسة المشيخيَّة المصريَّة أحد أثرياء المصريين، مِن مُلاك الأراضي، بضرورة إعتاق عبيده شرطًا لقبوله في عضويَّة الكنيسة، ورغم شيوع هذه المُمارسة في المجتمع المصريّ آنذاك، إلّا أنَّ الكنيسة أصرّت على أنَّ الاستعباد خطيَّة تخالف تعاليم كلمة اللّٰهِ، ولا يمكن التَّساهل معها، ما أسفر في النِّهاية عن خضوع الرجل للكتاب المقدَّس وتحرِّيره لعبيده، ومن ثَم أصبح عضوًا في الكنيسة المشيخيَّة المصريَّة.
بالتأكيد، فتح هذا الفعل طاقة نور نحو تفكير وتحرك لخلخلة فكرة العبوديَّة في الذِّهنيَّة المصريَّة، أو على الأقل حرَّكَ راكدًا. هذا ملمح من الدَّور النَّبويّ للكنيسة، المُنطلق من فهم وتأصيل كتابيّ، لا يُهادن، ولا يلتف على الحق. في سياقنا وواقعنا تزداد كل يوم القضايا التي تحتاج صوتًا نبويًّا يرتفع في مواجهة الظلم والعنصريَّة والقهر وكل أشكال الجرائم في حق الإنسانيَّة. فهل ما زالت الكنيسة ترفع صوتها النَّبويّ في وجه المجرمين؟ هل ما زال الإنسان وحقوقه أولويتها؟ هل ما زالت الكنيسة ملحًا ونورًا للعالم؟ لماذا بتنا نبحث عن صوت الكنيسة في قضايانا العامة واليومية فيجيبنا الصمت القاتل؟!
كما اقترحت سابقًا مؤتمرًا سنويًا لإصلاح الكنيسة، اقترحت أيضًا مؤتمرًا سنويًا يهتم بالكنيسة والشأن العام، يطرح المؤتمر رؤى لاهوتيَّة لواقعنا وتحدياته وخطوات إصلاحيَّة لصالح الإنسانيَّة، ويساهم في تفعيل دور الكنيسة في العالم ويضبط بوصلتها في اتجاهها الصحيح لتبقى دائمًا مُصْلَحَة.
ثامنًا، في الانضباط
عدَّ كالڤن التَّأديب الكنسيّ سمة ثالثة للكنيسة المُصلَحة، إلى جانب الوعظ باستقامة بالإنجيل، والممارسة المنضبطة لسري الكنيسة؛ وشمل هذا -في رأيه- كُل من الراعي والرعية، إذ كان موضوع الخطية والمُصالحة هو لُب دعوة الإصلاح. الانضباط أمر مهم للحفاظ على دورة العمل والهُوية أيضًا. لا يمكن تخيل أن تقوم جماعة أو حضارة دون قواعد وقوانين تضبطها، وآلية لضمان سيرها واحترامها، وإلا تشرذمت الجماعة وانفرط العقد.
من المهم أن تتفق الجماعة على نظام، ثم تمتثل له وتتابع تنفيذه بدقة، فإن احتاجت لتحديثه وجب عليها أن تتفق ثانية، أما أن تتفق الجماعة على دستور ويتعهد أتباعه باحترامه والسير وفقه ثم يخرجون عليه في الصغيرة قبل الكبيرة فهذا إفساد للجماعة وتقطيع لأوصالها.
والسؤال المطروح، هل الكنيسة اليوم مهتمة بالتعريف بدستورها واتِّباعه؟ هل تحتاج الكنيسة لتطوير دستورها؟ وإن كان، فهل هيأت المُناخ وتمكنت من الآليَّة؟ ماذا جنينا من امتهان الدستور والنظام طيلة عقود؟ لمصلحة من هذا الترهل الإداريّ والفشل التَّنظيميّ؟ هل تتوفر الإرادة لدى المجالس والمجامع والسنودس للاهتمام بالانضباط وتفعيل التأديب الكنسيّ؟ الانضباط هو الآليَّة لبقاء الكنيسة دائمًا مُصْلَحَة.
تاسعًا: في المُساواة
ساهمت دعاوى الإصلاح بكهنوت جميع المؤمنين في تحطيم أغلال السُلطة، بل ضربت منظومة السُلطة الهَرميّة في مقتلٍ، وقد تعدى تأثير هذه النداءات حدود الكنيسة لينسحب إلى المجتمع والحياة السياسيّة، فكان مُحرِكًا للحركات التَّحرريّة، والانتفاضات الشَّعبيّة، وباعثًا للنَّزعة القوميّة لدى الشُّعوب. كما كان لنظام تأسيس الكنيسة الديموقراطيّ الذي وضع لبِنَته الأولى المُصلحون، تأثيرًا لا يُمكن إنكاره على سائر الأنظمة السياسيّة الأوربيّة، التي استقرت فيها فكرة المساواة، والتمثيل؛ فلا يُمكن أن يَظِنُ ظَانٌ مثلًا أن دعائم الديموقراطيّة المُتأصلة في أرجاء أوروبا الآن، والتي لم تكن معروفة في القرون الوسطى، لم يكُن للإصلاح الإنجيليّ دورًا في إرسائها!
غير أن الأمر أيضًا لم يسلم من التشويه، فمع تقدّم المسيرة، وانحِراف البعض عن المسار الأصيل، ظهرت الفرديّة لتضرب كنائسنا كمتلازمة لمبدأ كهنوت جميع المؤمنين، ونظرًا لسوء الفهم، أو التطرف، ظهرت نزعات تُنادي بعدم احتياج الفرد للجماعة، فما دور الجماعة إن كنت أنا كاهن نفسي! مُتناسين أن دور الكاهن يتخطى ذلك في أن يكون الفرد كاهنًا للآخر، يحمل له البِشارة، ويُصلي لأجله، ويُشاركه، ويتبادلان التَّعليم، والمشورة!
فهل تُقدم كنائسنا تعليمًا واضحًا، يوضح علاقة الفرد بالجماعة، ولا يكرِّس لسُلطة هرميّة فوقيّة، أو يُهادِن فوضويّة شعبيّة، أو دعاوى الانعزاليّة والشرذمة؟ وعي الجماعة بقيمة الفرد، ووعي الفرد بحاجته للجماعة، سبيل آخر لإبقاء الكنيسة دائمًا مُصْلَحَة.
عاشرًا، في ديمومة الإصلاح
«تَغَيَّرُوا عَنْ شَكْلِكُمْ بِتَجْدِيدِ أَذْهَانِكُمْ، لِتَخْتَبِرُوا مَا هِيَ إِرَادَةُ اللهِ…» (رو 12: 2) تبلورت هذه الآية في الفكر الإصلاحيّ في المُصطلح الذي صاغه (چودوكس ڤان لودينشتاين) في أحد كتبه عام 1674 عندما قال: «الكنيسة المُصلحة تُصْلَح دائمًا.» Semper Reformanda. كان (لودينشتاين) راعيًا في الكنيسة المُصلحة في هولندا. وشهدَ كثيرًا من التغييرات في الكنيسة المُصْلَحة، بما في ذلك تطوير لاهوت العهد، والصراعات الداخليَّة للكنائس المحليَّة لاستخدام الأرغن كأداة موسيقيَّة في أوقات العبادة.
«دائمًا مُصْلَحَة» هو السَّبيل والضَّمان لاستمراريّة الإصلاح وديمومته. وهو ما يعني استمراريّة الكنيسة في مُمارسة النقد الذَّاتي لعقيدتها، وعبادتها، وإرساليتها، ونظامها، في ضوء كلمة الله، هذا النقد هو سبيل الكنيسة للبُعد عن التكلُّس والتحجر والجمود، الذي يُبعدها مع الوقت عن لمسات الله المُهَذِّبة والهادية لها؛ هو الإطار الذي يُبقي الكنيسة مُتحركةً، ساعيةً نحو الله، من خلال السعي تجاه فهم الله، وتوقفها عن هذا السعي لا يعني شيئًا إلا أنها فجأة قد قررت أنها بخير، وأنَّ الأمور على أفضل ما يكون! وعندها تصبح -عوضًا عن المسيح- رأسًا لنفسها! وارتباطًا بالنقطة السابقة، فما قدمه (ديترتش بنهوفر) من تصحيحٍ، ورأب للصدع الذي ضرب جسد المجتمع الألمانيّ، يُمكننا فهمه في ضوء ديمومة الإصلاح كتصحيح وإصلاحٍ للفهم المأخوذ عمَّ كتبه (لوثر) عن اليهود، وعدّه بعضٌ نواة الأزمة في المجتمع الألمانيّ.
لكن، هل معنى «دائمًا مُصْلَحة» أي دائمًا متغيرة؟ هل يمكن أن نعدها دعوة للتجديد والحداثة؟ وهل التجديد هو الابتداع؟
في الاحتفال بمرور 500 عام على الإصلاح، وُجِّه هذا السؤال إلى منصة ليجونير التي اعتلاها خمسة من كبار اللاهوتيين، وتحديدًا إلى آر. سي. سپرول وسنكلير فيرجسون. أجاب سپرول إنَّ الأصل في الإصلاح هو العودة للكتاب المقدَّس وديمومة الإصلاح في ديمومة العودة للكتاب المقدَّس وحده، وحذف كل ابتداع خالفه، بينما أكد فيرجسون أنَّ الكنيسة المُصْلَحة إنما أُصلِحت بإعادتها إلى جادة الكتاب المقدس، وهي تحتاج دائمًا أن تبقى مُصْلَحة بالعودة للكتاب المقدَّس والسير وفقه، لا بتغييره وتبني قوالب ومناهج ووسائط أخرى.
وعليه، يجب فهم ديمومة الإصلاح بوصفها دعوة للعودة للكلمة المقدَّسة والخضوع لها، لا بوصفها دعوة تغيير للتغيير وتطوير للتطوير، ديمومة الإصلاح ليست أبدًا دعوة لتقديم ما يطلبه المستمعون. ولهذا السبب اخترت أن أجعلها ختام حديثنا معًا؛ فهذه العشريَّة ما هي إلا مُمارسة للنقد الذاتيّ، وما محاولة الإجابة عن الأسئلة التي طرحتها فيها إلا بهدف تطبيق إحدى سِمات الكنيسة المُصلَحَة أن تبقى دائمًا مُصلَحَة. وأخيرًا، هل تُمارس كنائسنا بشكل دائم نقد الذات وتقييم الأداء، أم انشغلت بنقد أو نقض الآخر؟
في الأخير، صلاتي أن تبقى الكنيسة المُصلَحة مُصلَحةً بحسب الكتاب المقدَّس وحده.