الهدى 1256- 1259 مايو – أغسطس 2024
كثُرَ في الآونة الأخيرة، الحديث حول مُصطلح ’’الصُّوفيّة‘‘ وخُلِطَت الأوراق بينها وبين ’’التَّقوى المَسِيحيَّة الكتابيَّة‘‘ الحقّة. فهل هو اختلاف في المُسمَّيات أم اختلاف في المفهوم؟ في هذا المقال لا أهدف لدراسة شاملة لهذا الموضوع الواسع، ولكنّني أقدِّم مفاتيح بسيطة، علَّها تُساعد في تحديد المفاهيم وتبيين الخَلْط. أبدأ بلمحةٍ تاريخيَّةٍ عن الصُّوفيّةِ وأبرز روادها، ثم أحاول أن أحدد الإطار الكتابيّ للتَّقوى المسيحيَّة، أستعرض بعدها أوجه الشَّبهِ بين الصُّوفيَّةِ والتَّقوى المسيحيَّةِ، والتي ربما كانت السَّبب في هذا الخَلْط، وأختتم حديثي بتقديم أبرز الاختلافات بين الصُّوفيَّة والتَّقوى المسيحيَّة.
محاولة تأطير
يُعرَف مُصطلح التَّصَوُّف بغموضه وتعقيده. حتَّى أشهر النّظريات التي قُدِّمت لتفسير المُصطلح -مثل كونه مشتق من صوفيا اليونانيّة، أو الصُّوف، أو التَّطهر، تبدو مرتبكة بعض الشّيء. وكما قال (إيفان ب. هوارد): “لا يوجد تعريف واحد يُغطي كل الشُّروط الكافية والأساسية للتَّصَوُّف، ولا يوجد إجماع على مُصطلحات مُعينة لتعريفه.” قَدّم الفيلسوف (واينفريد كوردوان) تعريفًا عامًا يقول: “ارتباطٌ مُباشرٌ بالمُطلَق.“ نلاحظ في تعريف (كوردوان) أنَّ هُناك مُطلَق، ويختلف ذلك المُطلَق عمّا تُدركه الحواس، وأنَّ التَّواصل مع ذلك المُطلَق مُمكنًا. كما أنَّ الاتصال بين السَّاعي والمُطلَق اتصالًا مباشرًا، ودون وسيط. ينطبق هذا التَّعريف على المُتَصَوِّفة المسيحيين، كما على متصوفة الدِّيانات الشَّرقيَّة مثل الهندوسيَّة والإسلام.
لمحة تاريخيّة

قدَّم ماكسيموس المُعترف ما عُرف بـ ”اللّاهوت الصُّوفيّ“، الذي يشدد على السَّبيل والمراحل التي تقود المسيحيّ إلى شركة الثّالوث. وصُنِّفت شخصيات مِثل أوغسطينوس وتوما الإكوينيّ وچون ويسلي وجوناثان إدواردز على أنهم يؤمنون بشكل مِن أشكال اللّاهوت الصُّوفيّ ويُمارسون شكلًا من أشكال المُمارسات الصُّوفِيَّة. من أبرز علامات التَّصَوُّف من القرن الرّابع إلى القرن الثّامن عشر، يجيء غريغوريوس النّيصيّ، النَّصّ المنحول لديونيسيوس الأريوباغيّ، جون رويسبروك، كتاب ”سحابة المجهول“، جوليان من النورويتش، تيريزا الأفيلاويَّة، يوحنا الصَّليب، فرانسوا دي سيلز، فرانسوا فينلون، جورج فوكس، جون وولمان. أمَّا في القرن العشرين فيجيء، توماس ميرتون، وهنري نويين، وبرينان مانينغ، وريتشارد فوستر، و أ. و. توزر.
أُسس مفهوم الطّرق الصُّوفيَّة مِن قِبَل أكثر المتصوفين تطرّفًا، وهم كاتبا القرن السّادس عشر الأشهر، تيريزا الأفيلاويَّة، صاحبة كتاب ’’القصر الباطنيّ‘‘،[1] ويوحنا الصَّليب، صاحب كتاب ’’ليلة الرُّوح المُظلمة/اللَّيل المُظلم.‘‘ يرسم هذان العملان الطرُّق الصُّوفِيَّة كطريق ثلاثيّ المراحل يصل إلى الاتحاد مع الله. يبدأ باليقظة أو الصَّحوة؛ ثمَّ التَّطهُّر؛ ثمَّ الاستنارة. ولكنه في نهاية المطاف عاجز عن تحقيق اتحاد حقيقيّ مع الله. وللوصول إلى ذلك الاتحاد المزعوم، يجب على المرء أن يمُر بحالة أخرى من ليلة الرُّوح المُظلمة.
تُشبه الصَّحوة لحظة بداية حياة الإيمان. وهذا ليس عملًا في حدِّ ذاته وإنما إدراكًا مُتزايدًا يتبعه. التَّطهُر، هو حيث يواجه الصُّوفيّ الصِّراع الحياتيّ بين ذلك الوعي الرّوحيّ المُتنامي والماديَّة. ولا بُد من تطهير تلك الأشواق من خلال الإماتة المُستمرة. يُوصل هذا إلى المحطّة الثّالثة، الاستنارة، حيث حالة فائقة من الفرح حين تستنير روح الصُّوفيّ. ترتبط تلك الخطوة في العملية الصُّوفيَّة بالرؤى، واختبارات مليئة بالنّشوة، وبابتهاج لا يوصف. لكن بالرّغم من فرحة الاستنارة، يُدرك المُتَصوِّفة أنَّها ترتبط بالذَّات، ويجب عليهم أن يستمروا في خوض مراحل أعمق مِن التَّطهير والإخلاء وصولًا إلى ليلة الرّوح المُظلمة. يشرح يوحنا الصَّليب في كتابه أنَّ حتَّى الفرح بالتّواجد في محضر الله يجب أن يُقتَل ويُطَهَر كونه نابعًا مِن الذَّات! بحسب تصوّره، يجب على الشّخص أن يموت ليس فقط عن ذاته الخاطئة -كما في الخطوة الثّانية- بل عن ذاته بالكامل! وعندئذٍ فقط، سيختبر الشّخص الخطوة الخامسة وهي الاتّحاد مع الله، حيث يصبح الاختبار الصُّوفيّ تحولًا حقيقيًا لا يوصف واتحاد مع المُطلَق، يصبح فيه الاثنان واحدًا.
التَّقوى المسيحيَّة الكتابيَّة
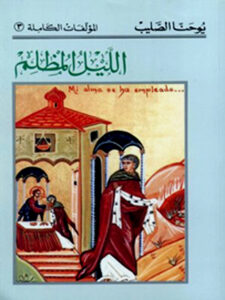
يُسمي الكتاب المقدَّس الحياة مع الله الحياة الأبديَّة، ننال هذه الحياة فقط مِن خلال العمل الوسائطيّ للابن المُتجسد المصلوب المُقام، والذي يملُك من الآن وإلى الأبد. فهو الذي قال: ”أَنَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ وَٱلْحَقُّ وَٱلْحَيَاةُ لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى ٱلْآبِ إِلَّا بِي.“ (يوحنّا 14: 6) وبالمِثل، فإن ”المُعَزي“، ”روح الحق“ يشهد للمسيح (يوحنا 15: 26)، ويُعلّمنا، ويُذكّرنا بكل ما علّمهُ المسيح على الأرضِ. (يوحنا 14: 26). وعليه، يُمكن تعريف التَّقوى المسيحيَّة الكتابيَّة على أنها، السَّعي نحو الالتصاق بالله الثَّالوث وَفقًا لما أعلنهُ عن ذاته، والذي تحرِّكه وتدفعه النِّعمة ويُنتج ثمر الرُّوح القدس.
هدف التَّقوى الكتابيَّة هو هدف الحياة المسيحيَّة ذاتها، أيْ، أن نُمَجد الله الثّالوث مِن خلال التَّمتع بمعرفته والشَّركة معه ونحن نتغير إلى صورته. لذا يتعين علينا أن نفعل كلَّ شيءٍ ”لِمَجْدِ ٱللهِ“ (كورنثوس الأولى 10: 31). فالهدف الأساس من عَمل المسيح أنْ ”…يُقَرِّبَنَا إِلَى ٱللهِ“ (بطرس الأولى 3: 18). وإرادة الله من نحونا هي قداستنا (تسالونيكي الأولى 4: 3)، ولذا يجب علينا أن نُرَوِّضُ أنفسنا على التَّقوى (تيموثاوس الأولى 4: 7). ونعمل ذلك وَفقًا لخطة الله التي عيّنها لنا أن نكون: ”مُشَابِهِينَ صُورَةَ ٱبْنِهِ.“ (رومية 8: 29) ولتحقيق تلك الغاية، علينا الانخراط في المُمارسات الرُّوحيّة، أي وسائط النِّعمة -تلك العطايا الإلهيّة التي علينا الاشتراك فيها باستمرار أثناء سعينا لنكون في شركة مع الله- مِن أجل مجده وحده، لنتغيّر إلى صورته ونُماثل طبيعته في القداسة، ’’لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: «كُونُوا قِدِّيسِينَ لأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ».‘‘ (1 بط 1: 16) مِثل الصَّلاة الفرديَّة والجماعيَّة والفرائض. لكن من الأمور الأساسيَّة في تلك المُمارسات اللّاهوتيَّة أن تُبنى على أساس كتابيّ صحيح. لذلك، يدعونا الرسول بولس -بالرُّوح القُدُس- قائلًا: ”ٱمْتَحِنُوا كُلَّ شَيْءٍ، تَمَسَّكُوا بِٱلْحَسَنِ.“ (تسالونيكي الأولى 5: 21) إذن، التَّقوى المسيحيَّة هي مُمارسة لا بُدّ أن تكون كتابيَّةً، وليست إضافةً أو اجتهادًا بشريًّا.
باختصار، ما أود أن أُركِّز عليه من استعراض ما سبق هو أنّ التَّقوى المسيحيَّة الكتابيَّة ليست درجًا تسلسليًا نرتقيه فنترقى، لكنَّها سبيلًا افتتحه ودشَّنه لنا ابن الله بدمه، ووهبنا أن نسلك فيه مع الرّوح القدس بنعمته -بوصفنا مبرَّرين أمام الله ولنا كلّ برّ المسيح أمامه، نتغيّر إلى صورته وقصده لمجده، لا لنخلُص. نسلك لأنَّنا، لا نسلك لكي نكون.
التَّصوّف والتَّقوى الكتابيَّة مساحات مشتركة
يشترك المتصوّفة المسيحيون مع سائر المسيحيين في عقيدة الثَّالوث، فهم يؤمنون بالآب صاحب المبادرة والسُلطان، والابن مُتمم الخلاص، والرُّوح القُدُس مُتَمِّمُ الفداء. هذا على عكس سعي بعض التّيارات الأخرى التي تدّعي المسيحيَّة (مثل المورمون وشهود يهوه) إلى تتبنى إمّا الأريوسيَّة أو تعدّد الآلهة. يدرك المسيحيّ الصُّوفيّ أنَّ الله مُتسامٍ جدًا وقريب في آنٍ واحدٍ. والله المُتسامي الذي له مُطلق السُّلطان على كل شيءٍ، هو دائم الحضور وسط شعب عهده. ويدرك أيضًا المسيحيّ الصُّوفيّ أنَّ رؤية الله هي الخير الأعظم. ولا يكتفي المسيحيّ الصُّوفيّ بانتظار حدوث ذلك في مستقبلًا، لكنَّه يتوق إلى اختبار كلّ ملء الله (أفسس 3: 19) والاتّحاد معه (بطرس الثانية 1: 4)، والعمق الأبديّ لبهجة الوجود في محضره الآن (مزمور 16: 11).
يهتمّ الصُّوفيّ المسيحيّ بضرورة المقابلة الشخصيَّة والخاصّة مع الله بوصفها عنصُرًا أساسيًا مِن عناصر الحياة المسيحيَّة. وعلى الرّغم مِن النَّقد الذي سنقدّمه لاحقًا، يجب أن نمتدح جديتهم تجاه وصية يسوع: ”وأمّا أنتَ فمَتَى صَلَّيتَ فادخُلْ إلَى مِخدَعِكَ وأغلِقْ بابَكَ، وصَلِّ إلَى أبيكَ الّذي في الخَفاءِ“، وإيمانهم بوعده: ”فأبوكَ الّذي يَرَى في الخَفاءِ يُجازيكَ عَلانيَةً“. (متى 6: 6). كما يشترك المتصوِّفة معنا في إدراك أهمية التّشديد على القلب. فقد نمتلك المعرفة والتّصديق، دون الثّقة. ويؤمنون أيضًا مثلنا بالعناصر السَّرائريَّة في اللّقاء مع الله، تلك التي قد تتحدى التّفسير العقليّ. وهم مثلنا يبتهجون بما قد لا نستوعبه بالكامل، ويقفون في اندهاش أمام ’’غِنَى المَسيحِ الّذي لا يُستَقصَى‘‘ (أفسس 3: 8) ومحبة الله”الفائقَةَ المَعرِفَةِ“ (أفسس 3: 19) وطُرقه التي لا يُمكن استقصائها (رومية 11: 33)، ويفرحون بحقيقة أنَّه لا يقدر أحد أن يعرف فكر الرَّبِّ بالكامل (رومية 11: 34). وأخيرًا، عاجزون من نفسهم وينتظرون تدخلًا إلهيًّا. في ضوء ما سبق، هناك عديدٌ مِن الجوانب الجديرة بالثَّناء فيما يُعرف بالتَّصوّف المسيحيّ، خاصّة فيما يتعلق بالاشتياق والجوع نحو الله. ولكن لسوء الحظ، يوجد كثيرٌ مِن القصور اللّاهوتيَّ.
التَّصوّف والتَّقوى الكتابيَّة اختلافات مُمَيِّزة
ينظر المتصوِّفة المسيحيّون نظرة شديدة التّفاؤل إلى الطبيعة البشريَّة. فصحيح أنَّهم لا يعتقدون أن اختباراتهم الصُّوفيّة ذاتيَّة -كما البيلاجيّون-[2] لكن لاحظ، على سبيل المثال، فكرة جورج فوكس أنَّ الجميع ولدوا وبداخلهم ”شرارة إلهيّة“. جميع البشر -بغض النّظر عن حالتهم الرُّوحيّة- يمتلكون نورًا إلهيًّا في داخلهم أو شكل من أشكال النِّعمة، وهذا يعني أنَّ الفارق الجوهريّ بين من يتقدّمون في طريق الاستنارة ومن يصلون إلى الاتّحاد هو قوّة إرادتهم القادرة على تحديد مصيرهم، وهذا عكس ما يُعلنه الكتاب المقدّس بوضوح في مواضع عديدة. (أفسس 2: 1- 7؛ رومية 5: 6؛ رومية 7: 18؛ رومية 8: 7؛ كولوسي 1: 21؛ تكوين 8: 21؛ انظر تكوين 6: 5؛ رومية 3: 10–12)، وما يُقِرَّه إقرار إيمان وستمنستر الذي يقول عن فساد طبيعتنا: “صرنا نافرين تمامًا من كلّ صلاحٍ، وعاجزين عن فعله، ومقاومين له، وميالين كليًّا نحو كلِّ شر…”
يجنح المتصوِّفة -شأنهم في ذلك شأن اللّاهوت اللّيبراليّ- إلى التّفرقة بين العقل والقلب. مُعلين دور ”القلب“ على دور ”العقل“، إذ لا يخضع الاختبار الصُّوفيّ للفحص أو التّحليل العقلانيّ. ففي حين تدعونا كلمة الله إلى أن نملأ قلوبنا بوعود الله العظيمة والثَّمينة (بطرس الثّانية 1: 3- 7) وأن نلهج في كلمته ليلًا ونهارًا (يشوع 1: 8)، فهي بالنِّسبة لنا خبزنا، أي طعامنا اليوميّ (متَّى 4: 4).
يُقلل المتصوِّفة المسيحيّون مِن ضرورة وحتميّة عمل نعمة الله. كتابيًّا، نفهم من كلمة الله أن هُناك نعمة للغفران ونعمة لتمكين المؤمن من أجل المثابرة. فصحيح أنَّنا ’’بالنِّعمة مُخلَّصون‘‘ (أفسس 2: 8- 9)، إلّا إنَّنا نجد بولس يمنح قُرَّاءهُ بانتظام بركة ” النِّعمة والسَّلام“. كما أنَّنا نقرأ عن غضبه الشَّديد على ذلك الإنجيل الآخر الذي رَوَّج إلى الانتقال إلى الأعمال والجهاد كوسيلة للنّمو الرُّوحيّ (غلاطية 3: 3). غالبًا ما يُعطينا التَّصوّف المسيحيّ انطباعًا أنّ الله يبدأ العمليّة، ولكن الأمر في النهاية مرهون بمثابرتنا، لكنَّ تعلمنا كلمة الله أنَّ الله لا يبدأ العمل في قلب الإنسان فحسب، ولكنه يظل يعمل ويُجدد ويمنح القوّة والإرادة، ويحفظ ويُمكّن حتَّى النِّهاية. كما يُركّز المسيحيّ الصُّوفيّ على المسيح باعتباره النّموذج والمثال، واضعًا في الظلِّ حقيقة أنَّ المسيح هو المُخلّص الذي مات بديلًا عنّا. بيد أنَّ كفارة المسيح لا تقتصر على الغفران فحسب، بل تهبنا كامل برّ المسيح أمام الله. ولا يستردنا الخلاص إلى طبيعة آدم الأولى في عدن، لكنَّه يهبنا التَّبني. ويُرهن خلاصنا بعمل المسيح لا أعمالنا. فلا نقضي حياتنا في رعب أن نفقد يومًا مقامنا.
المنظور القاصر للصوفيَّة المسيحيَّة عن حقيقة التَّبرير في المسيح، يدفع المسيحيّ الصُّوفيّ ليجاهد علّه يصل، وهو ما كفله المسيح الذي مات بديلًا عنَّا. كما يسعى جاهدًا لتحقيق برَّه الذَّاتيّ، غير مُدركٍ أن ما يُصارع للوصول إليه هو في الأساس مُقدَم له كعطية مجانيَّة. وفي حين إنّ اتحادنا بالمسيح ثابت ومضمون، فإن التّواصل مع الله يُمكن أن يشهد بعض التّقلبات في رحلة تقديسنا، لكنَّه أبدًا لا يغير مقامنا. يسعى المسيحيّ الصُّوفيّ نحو شيءٍ رائع وهو أن يكون في محضر الله الكامل والنِّهائي مِن دون أي خطيَّة أو وصمة وأن يتحد بشكلٍ كاملٍ مع الله، ولكنه ربما نسيّ أو تناسى أن هذا الاتّحاد الكامل لن يتحقق سوى في الأبديَّة، وإلى حين حدوث ذلك، ينبغي أن ينصب تركيزنا على الشّركة مع الله مِن خلال وسائط النِّعمة التي عيّنها لنا، ومِن خلال حياة التّلمذة الشّخصيّة والتّقديس، والعبادة الجماعيَّة، والسَّعي لمعرفة أعمق بالله، وأن نحبه بكل قلوبنا وأن نُحب أقرباءنا كأنفسنا.
يُخفق المسيحيّ الصُّوفيّ حين يسعى لاختبار مباشر مع الله بلا وسيط. تعلّمنا كلمة الله، أنَّنا يجب أن نختبر الله بالطَّريقة التي عيَّنها هو. نعود ونذكّر أنفسنا أنّ المسيح هو الوسيط كما صرَّح بولس في تيموثاوس الأولى 2: 5-6 والطّريق الوحيد إلى الآب مِن خلالهُ (يوحنا 14: 6؛ أفسس 18:2). كما يشترك كل من الابن والروح القُدُس في التَّشفع مِن أجلنا أمام الآب، ومعونة ضعفنا في الصَّلاة (رومية 8: 27) .ومن جهةٍ أخرى، يجب أن نُدرك أن الله أعلن عن ذاته بأنواع وطرائق كثيرة، ولكن الإعلان الأكمل هو أنه كلَمنا ’’في ابنِهِ [كلمته المتجسِّدة]‘‘ (العبرانيين 1: 2)، ونحن نتقابل مع كلمته المتجسِّدة مِن خلال كلمته المكتوبة. لذا، فلكلمة الله دورٌ محوريٌ غير قابل للاختزال في اختبارات أو كشوف أو ما شابه. وأي سعي لفصل الله عن كلمته، والمسيح عن عمله هو أمر غير كتابيّ وغير واقعيّ وغير مقبول بالمرَّة. وأي تجاوز للنِّظام الذي صمّمه الله ودور المسيح كالوسيط بين الله والناس يضعنا في جانب آخر مضادّ لكلمة الله.
هناك نزعة مُقلقة في التّقليد الصُّوفيّ الانعزاليّ. إذ يرى الصُّوفيّ أنَّ ذروة الإنجاز الرّوحيّ تتحقق حين يتخلّص مِن جميع المشتتات. حتَّى في الجماعات الصُّوفيَّة، تلتف الجماعة حول نفسها منعزلة عن العالم[3]. إنَّ ما يبدو سعيًا نبيلًا نحو الله يتضمن التّخلي عن جميع الملذّات الأرضيّة، لا يعُدَّه الكتاب المقدّس النّموذج الأكمل والأمثل للتّقوى. ربما تبدو فكرة انعزال المسيحيّين مِن المجتمع والانقطاع بأشباههم، فكرة مغرية، ولكنها ليست فكرة كتابيّة على الإطلاق. فنحن لا ننمو روحيًا فقط في حجراتنا عندما ننعزل، لكن حين نمارس إرساليتنا كنورٍ للعالم، وملحٍ للأرض، وفي مؤازرة بعضنا في جسد المسيح.
يُنظر الصُّوفيّ المسيحيّ بنظرة إلى الجسد والمادة على أنَّهما ضدٌّ للهِ بدلًا مِن كونهما عطيَّةً إلهيَّةً أُعطيت لنا لنستخدمها ونتمتع بها. فعندما أوصانا بولس قائلًا: ’’اهتَمّوا بما فوقُ لا بما علَى الأرض.‘‘ (كولوسي 3: 2)، لم يقصد أن يُشعل صراعًا بين ما هو ماديّ وما هو روحيّ. إذ إنَّه في الآيات التَّالية يشرح ذلك بتوضيح ما علينا أن نُميته فينا، وهي أعمال الجسد، لا الجسد ذاته. لذا، يجب أن يواجِه المسيحيّ الصُّوفيّ نفسه بحقيقة أنّ الرّسول بولس رَبَطَ بين الأرواح المُضلّة وتعاليم الشّياطين والامتناع عن الزّواج والأطعمة تحت ستار التقوى المُزيفة (تيموثاوس الأولى 4: 1).
وهكذا بينما تبدو القضيَّة من بعيد اختلاف في المُسميات، فإن المدقِّق الفاحص يكتشف أن الأمر أبعد من ذلك بكثير، إذ هو اختلاف في المفهوم. هذا ما يتَّضح لنا في نور كلمة الله الكاشف.
في النِّهاية، إذا أردنا أن تصير تقوانا كتابيَّة،
يجب أن يكون الكتاب المقدّس وحده هو معيارنا الوحيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القصر الباطنيّ El Castillo Interior هو كتاب نُشر الكتاب في عام 1577 مستوحى من رؤيتها عن الرّوح على شكل قلعة تحتوي على سبعة قصور، والتي كانت تفسرها على أنها رحلة الإيمان من خلال سبع مراحل، تنتهي بالاتحاد مع الله.
[2] بيلاجيوس، (354 – 418م) كان عالمًا لاهوتيًا دافع عن الإرادة الحرّة والزّهد. أنكر بيلاجيوس الحاجة إلى المعونة الإلهيَّة في أداء الأعمال الصَّالحة. قال إنَّ النَّعمة الوحيدة الضروريَّة هي إعلان النّاموس، وأن البشر لم يُجرحوا بخطيئة آدم وهم قادرون تمامًا على إتمام النّاموس دون معونة إلهيَّة. أنكر بيلاجيوس نظريّة أوغسطينوس عن الخطيئة الأصليّة. استشهد أتباعه بتثنية 24: 16 ’’لاَ يُقْتَلُ الآبَاءُ عَنِ الأَوْلاَدِ، وَلاَ يُقْتَلُ الأَوْلاَدُ عَنِ الآبَاءِ. كُلُّ إِنْسَانٍ بِخَطِيَّتِهِ يُقْتَلُ.‘‘ لدعم موقفهم. أعلن مجمع أفسس بيلاجيوس مهرطقًا عام 431. وأصبح تفسيره لعقيدة الإرادة الحرّة معروفًا باسم البيلاجيَّة.
[3] راجع مثلًا، نظام وقواعد وأنماط الرّهبانيّات المسيحيَّة في الكنائس التّقليديّة، والتي يمكن تصنيفها إلى قسمين رئيسين: الرّهبانيّات الجماعيّة، والرهبانيّات التّوحديّة.








